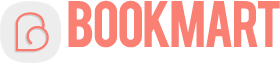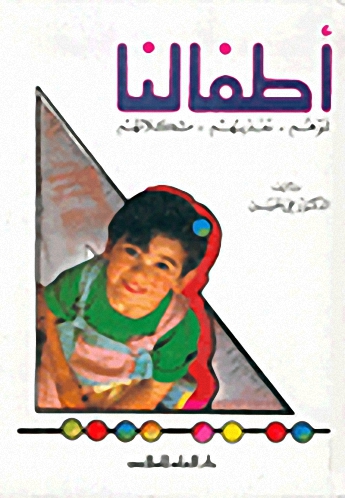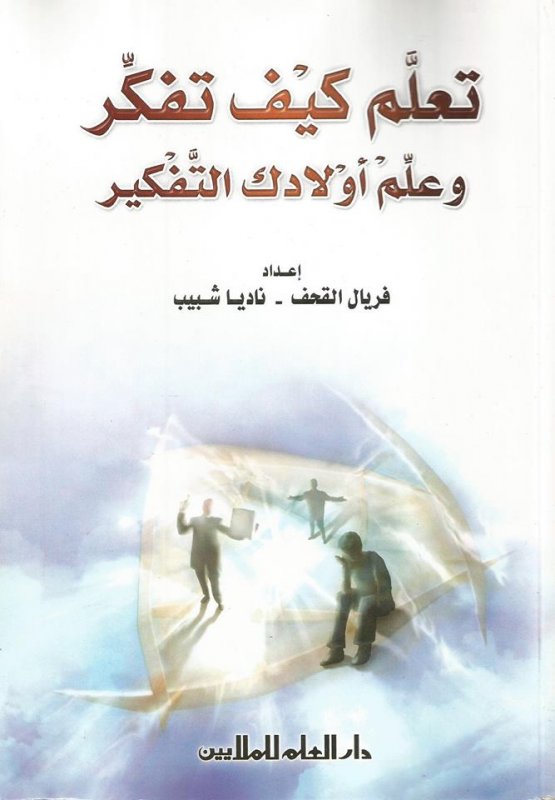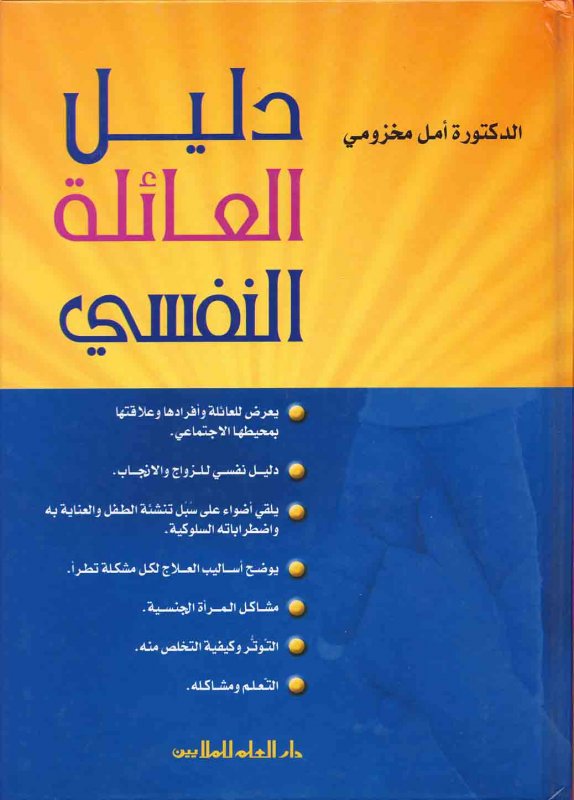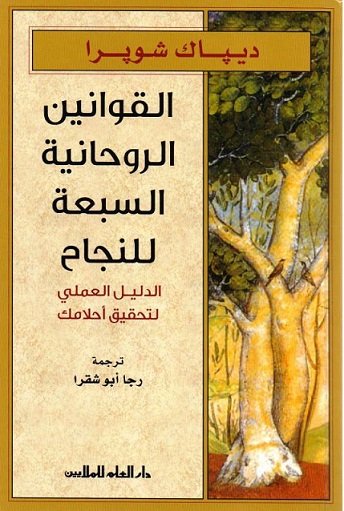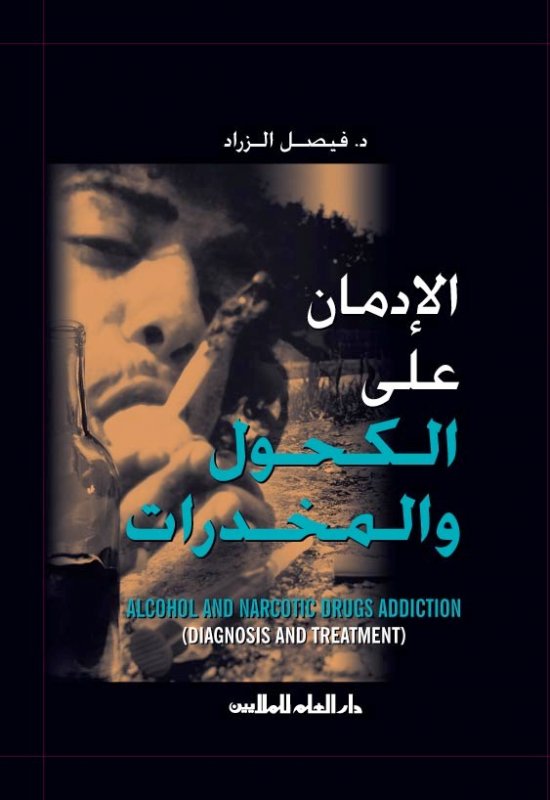أصول الهوية الحديثة وعللها
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
لا تنفك أسئلة الهوية عن المعاودة والظهور، كما أنها لا تنقطع رغم تغيّر إحداثيات المكان والزمان، إنها بمثابة الهواجس الأنطولوجية الثابتة والإرتدادية التي تبرر في كل مرة إستعادة قضايا الهوية الفردية والجماعية. ليست الهوية بأسئلتها المقضّة من قبيل: من أكون؟ ومن نكون؟ وما الكون؟ وما الكينونة أصلاً؟ ومن يكون إنساناً ومن لا يكونه؟ مجرد بؤرة صراع ثقافي أو عرقي أو ديني أو قومي، فهذا الصراع هو بالفعل وجه عن وجوه عنفوانها ودليل إستمرارها وثبات قيمها على إمتداد تاريخ الإنسان. ليست الهواجس الهروية مجرد أفق إيديولوجي يثير إحترازنا، بل إن هذا الأفق نفسه لا يعدو أن يكون سوى جزء من تجربتنا الإنسانية في العالم بكل تناقضاتها وصراعاتها وآلامها وإنتصاراتها. في تجربة الهوية الإنسانية لا نقيم في المجال التجريبي أي المحايث إلا على أمل الإنتقال منه إلى المفارق أي المتعالي، إنها بالفعل هذه المراوحة بين المحايث والمفارق، بين القيمة والفعل، بين الواقع والرجاء، ففي صلبها تلتقي مقولات الوجود المتعين والمجرّد، الجزء والكل، الأنا والآخر. إنها بإختصار وحدة الأضداد وصراعها، تمثل الهوية عصارة تجربة وجودنا في العالم، وهي تجربة تراها تتكرر في كل عملية خلق جديدة وفي كل مظاهر الصراع والنفوذ والقوة والموت والحرية والإستبعاد، فدلالتها اللغوية المباشرة تحيلنا إلى تلك الرغبة الحميمة لكل كائن في أن يكون متطابقاً مع كينونته، وبلغة الهوية أن يكون هو- هو لأن ذلك هو بالتحديد الشرط الرئيسي الذي يؤهله للإختلاف مع الغير، وبالتالي خوض مغامرة إظهار هذه الهوية المساوية في البدء مع ذاتها لهذا الغير ودعوته للإعتراف بهذا الإختلاف. تتكثف إذن رمزيات الخلق والصراع والموت والحرية والعبودية في جدلية الهو- هو والهو- الآخر دون أن تتعلق بمرحلة تاريخية أو ايستمية بعينها، لكونها هي بالتحديد المعنى أو مجموع المعاني المحددة لماهيّة الكائن. ومن هنا، فالتخلي عن رهان الهوية هو بمثابة التخلي عن المعاني القصية والغائرة في عمق التجربة الإنسانية، ليست الهوية إلا إجتماع وتقاطع هذه الإنشغالات والمباحث بشكل يتعذر الفصل بينها، فطبيعة المفهوم الفصفاضة والعائمة تمكنه من الإرتحال بيسر في مفترق طرق عدة تخصصات: فمن الهوية كمنطق صوري ورمزي يلاحق مواطن التناقض في الأشياء (موضوع علم المنطق) إلى الهوية كبحث عن وحدة مفترضة للوجود وتلاحق بدورها مواطن التكثر والحركة، باحثة عن أصل مرجعي ثابت (موضوع الميتافيزيقا)، وصولاً إلى تمثل العلوم الإنسانية المشترك لمسألة الهوية بإعتبارها آليات إثبات وجود فردية وجماعية مكتسبة، لا صلة لها بإحراج الماهية أو الأصل أو السكون. في أفق هذا التصور التعددي للهوية تتنزل مقاربة الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور، والذي اتخذه الباحث نموذجاً للبحث في أصول الهوية الحديثة وعلومها، مبيناً، وفي ثنايا بحثه هذا بأن هذا الفيلسوف إنما يتصدى منفرداً لمجمل التصورات المعرفية السالبة للهوية، بدءاً بتصور دافيدهيوم الذي اعتبرها وهماً يتكون بالعادة وصولاً إلى الريبية التحليلية التي تعتبرهما غير قابلة للتقول والتحديد المنطقي (قوتلوب فراجه) إلى تصورات معاصرية ولا سيما جون رولس الذي اعتبرها ضرباً في "أرض قاحلة وموحلة". ومتابعاً، يكشف الباحث بأنه ومقابل كل هذه الريبيات على أن تشارلز تايلور يعتبر أن هذه المواقف هي نتاج التعاطي مع مسائل الهوية المتشعبة بشكل إختزالي وأحادي، وهذه التصورات إنما تهدف إلى القضاء على الفهم الجامع للإنسان. وعلى هذه، فإن هذه المقاربة تفترض بأنه لا يمكن تعريف الإنسان إنطلاقاً من ذاته فحسب؛ بل من خلال مختلف علاقاته وتفاعلاته بذاته وبالآخر وبالعالم وبالوجود وبالطبيعة ومن ثم فإن تعريفنا للإنسان يجب أن يمتد إلى هذه الكونية الإنتمائية العميقة ويوحد هذا الشتات في تعريف شمولي قادر على إستيفاء الثراء التكويني للكائن. وأخيراً، يمكن القول بأن الفلسفة التايلورية، وبرأي الباحث، تتفتح على مختلف إنجازات الفلسفة القارية متجاوزة بذلك وظائفية الفلسفة التحليلية ولهذا قد يندهش القارئ لأول وهلة من تعددية مشارب هذه الفلسفة ومرونة إنتقالها وترحالها بين مختلف مباحث علوم الإنسان.