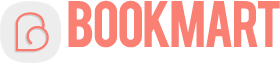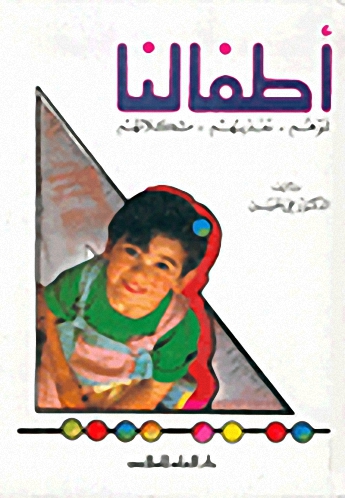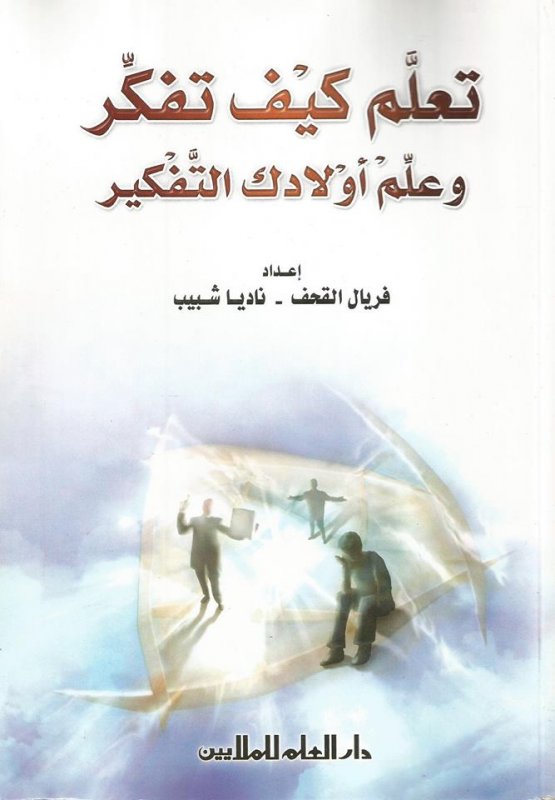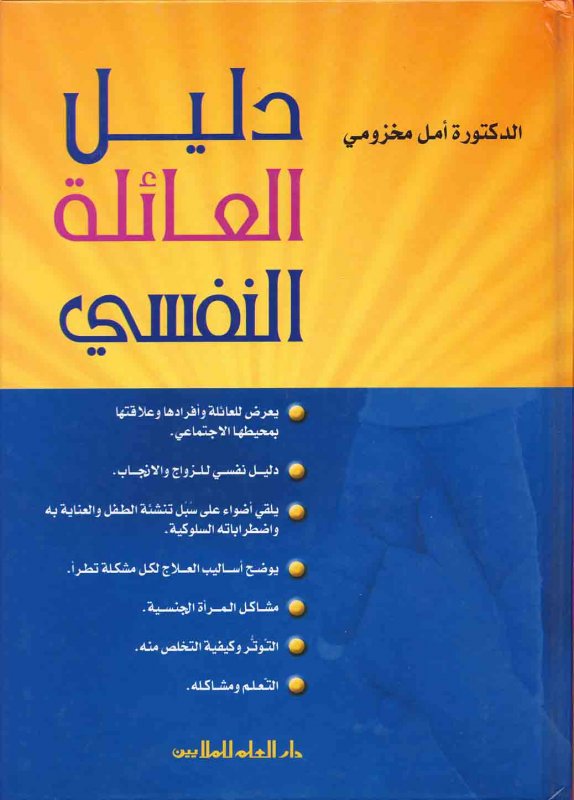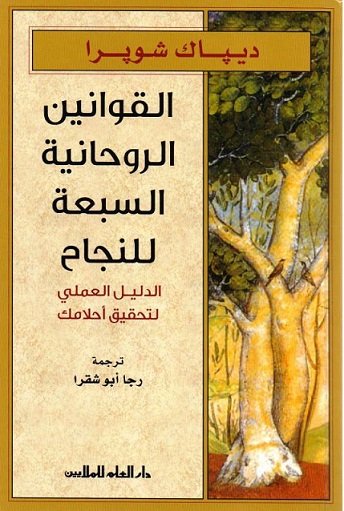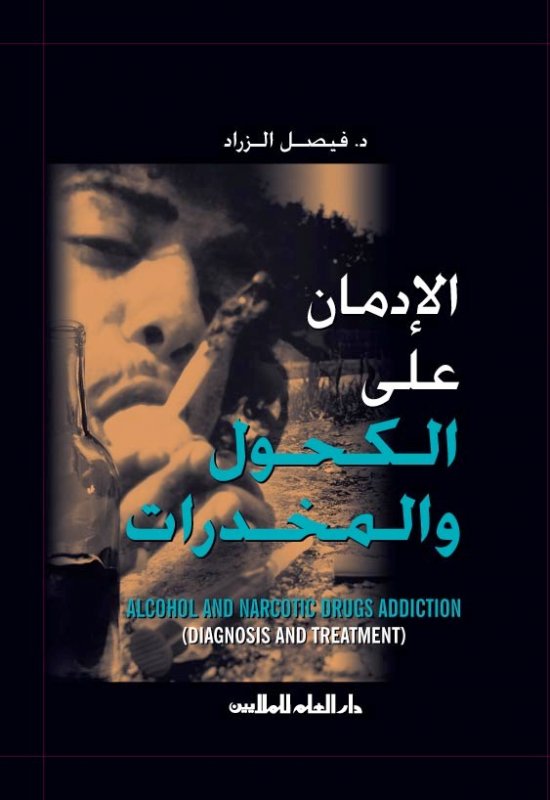الصحة النفسية
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
يشتمل هذا الكتاب على موضوعات متعددة ومتنوعة، جمعت في غالبيتها تحت مفهوم الصحة النفسية، غير أن نقاشها يمكن أن يتم كذلك من منظور المفاهيم العلمية الأخرى. فإذا بدت بعض الموضوعات تقليدية، وبعضها الآخر واقع خارج نطاق موضوعات الصحة النفسية، إلا أن موضوع ربطها بالصحة النفسية هو الذي جعل منها موضوعات تستحق المعالجة من هذا المنظور. وكما هو الحال في غالبية المواقف الحياتية، يضطر المرء للخضوع لمطالب لا يكون على قناعة تامة بها. وعليه فقد جرت إضافة بعض الموضوعات التي قد لا يكون موقعها الصحيح ضمن هذا الإطار، أو كان يمكن استيفائها بصورة أوسع في مكان آخر، غير أن هذا لا يخرج الكتاب عن إطاره في كل الأحوال. يغلب على غالبية كتب الصحة النفسية المؤلفة في اللغة العربية «تثبيتها» على مرحلة خمسينيات القرن العشرين، وتكرارها لنفسها وعن نفسها، ولقلة نادرة منها من استطاعت الخروج عن هذا الإطار، والتقدم قليلاً نحو ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. وكان كتابي الصحة النفسية للقوصي ونعيم الرفاعي هما الموجه العام الذي دارت وما زالت تدور كتب الصحة النفسية في إطارهما دون التمكن من الخروج كثيراً عن إطارهما فيما حدداه في أربعينيات وخمسينات القرن العشرين. ولعل واحد من أسباب هذا التثبيت كون مؤلفي هذين الكتابين كانا من أوائل العاملين في مجال الصحة النفسية في الوطن العربي، وكونهما حددا للجامعات المصرية والسورية مفردات منهاج الصحة النفسية وفق إطار كتابيهما. وأخذت كثير من الجامعات العربية هذا التوصيف أو توصيفاً هجيناً، لا يختلف كثيراً عن الأصل. ومع الأخذ بعين الاعتبار «ثبات» إن لم نقل «جمود» اللوائح التوصيفية للمقررات الجامعية، لأسباب كثيرة، منها ربط أي تعديل في محتويات المقررات وتوصيفها بمراسيم عليا، وأسباب إدارية ومالية لا مجال لذكرها هنا، فإن الخروج عن هذا الإطار قاد ويقود باستمرار إلى النظر بريبة وتشكك إلى تلك النتاجات الخارجة عن هذا الإطار، لأسباب تسويقية، واحتكارية. فيجد نفسه المؤلف في هذا المجال «يجتر» المحتوى نفسه تقريباً، بإطار جديد، وكأن هذه المفردات والكتب تحولت إلى حالة معيارية شبه «مقدسة» يصعب الخروج منها، وكأن فيها العلم كله، سارية المفعول وصالحة لكل زمان ومكان. ومع احترامنا وتقديرنا لمحتويات الكتابين المذكورين والجهد الذي بذل فيهما، إلا أننا نعتقد أنه آن الأوان للانتقال للقرن الواحد والعشرين بعد تثبيت لفترة خمسين سنة. وقد سعيت لإيجاد طريقة للتوليف أعبر منها قليلاً إلى ما بعد السبعينيات وصولاً لنهايات القرن العشرين، مثبتاً تارة، وناكصاً تارة أخرى، ونامياً في خطوات لاحقة، فأرجو أن أكون قد وفقت قليلاً. حاولت في هذا الكتاب أن أقدم خلاصة ما أمكن لي أن أصل إليه، «مولفاً» ما استطعت «توليفه» ضمن رؤية اعتقدت أنها قد توصل للهدف، محاولاً قدر الإمكان تقديم المادة من زوايا متعددة، ومن منظور جديد، غير ما هو مألوف في الكتب التي تتناول الموضوع نفسه، ولم أنس أن ما قدمته يمثل خلاصة ما عمل عليه غيري لعقود وقرون والفضل يعود لهم في توفير مادة علمية قمت «بتوليفها» وتركيبها لا أكثر ولا أقل. وكلي رجاء أن يأتي ذلك اليوم الذي يكون لنا نحن العرب إسهاماتنا الأصيلة في هذا العلم، تأصيلاً وبحثاً، فلا نعود ناسخين مولفين، ولا أعتقد أن هذا اليوم بعيد، إذا تمسكنا بالعلم منهجياً. وإذا كان القارئ يبحث عن حقائق مطلقة في ثنايا هذا الكتاب، فسوف يخيب أمله، إذ لا توجد حقيقة مطلقة نهائية في العلم، وكل من يدعي وجود حقيقة علمية مطلقة، يكون قد جانب المنهج العلمي وطبيعة الفكر العلمي. فمنهج العلم وطبيعة الفكر العلمي تسعى دائماً نحو التفسير والتنبؤ لا إلى إيجاد الحقائق. والكتاب لا يعرض إلا مجموعة من الظواهر ويرصد ما أمكن من الوقائع المرتبطة بهذه الظواهر من زوايا عدة. وكل ما يتضمنه الكتاب عبارة عن «شبه حقائق» سارية المفعول حتى يثبت لنا العكس. يسعى كل باحث إلى أن يكون قد قدم عملاً متكاملاً، ويأمل ذلك باستمرار، ولكنه منذ اللحظة التي ينتهي بها يشعر أنه ما زال بعيداً عن الهدف المنشود، وكأنه لم يبدأ بعد، فيبدأ ثانية من جديد، أو يتابع ما كان قد انتهى إليه، منقحاً ومضيفاً، راجياً أن يستطيع ذلك. وعندما يكون سلاحه العلم، يصبح للسعي معنى وللعمل متعة حتى وإن ظل ساعياً، لا يستقر له قرار ولا يرتوي من نبع واحد، يظل يدور مجرياً ومختبراً، مقرناً، ومستنتجاً، باحثاً لا يكل، ساعياً لا يصل. فالوصول غاية تُنشد، ومستقر ينتهي، فهل للعلم نهاية؟