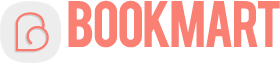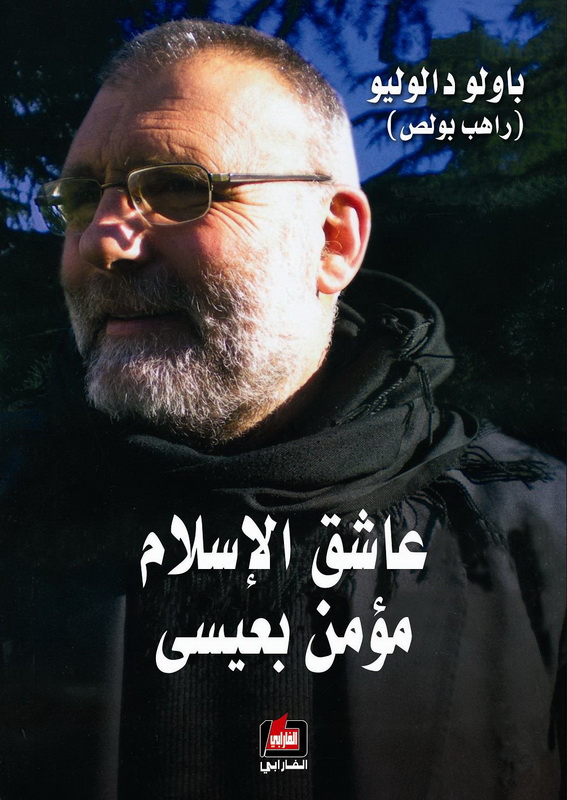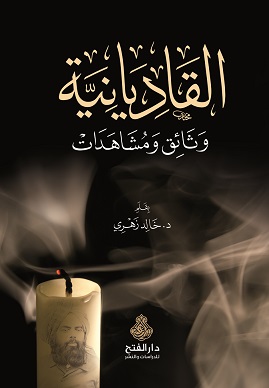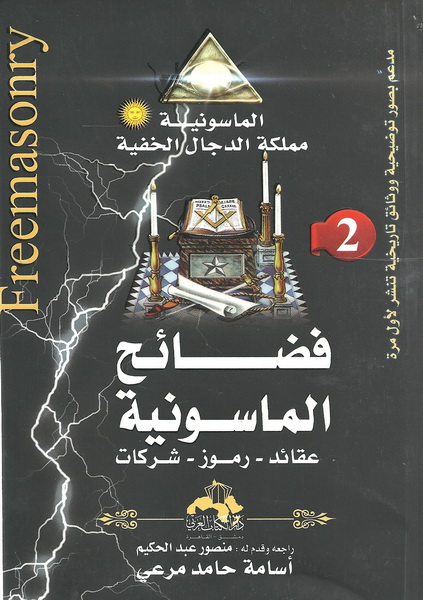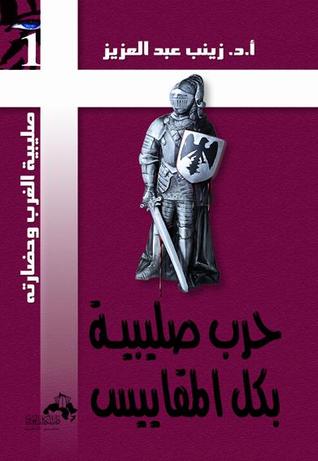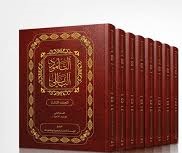
التلمود البابلي : 1 - 20
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
التلمود البابلي... لماذا؟* في واحد من أكبر مشاريع الترجمة على مستوى العالم العربي ظهرت أول ترجمة للتلمود البابلي باللغة العربية في عشرين مجلدا من القطع الكبير، بعد سنوات متواصلة من العمل الدؤوب قام بها عشرات المختصين تحت إشراف مركز دراسات الشرق الأوسط في عمّان، وكباحث في مجال الأديان المقارنة، وكواحد من الباحثين المشاركين في هذا المشروع، لاحظت مدى السعادة والتقدير التي تلقّى بها أصدقائي من أساتذة الجامعات والباحثين والمثقفين والمهتمين بالدراسات اليهودية والفكر الصهيوني وطلبة الدراسات العليا ظهور هذه الترجمة، ولكن إلى جانب هذا التقدير والسرور ظهرت أصوات نظرت الى إلمشروع بعين مختلفة، وأثارت بعض التساؤلات التي أرى من واجبي كمختص في الدراسات اليهودية توضيحها وتجليتها للقارئ العربي المستنير. إن ترجمة التلمود تتوجه في الأساس للأكاديميين والباحثين المختصين في الدراسات الدينية المقارنة، والمهتمين بالبحث في مصادر الفكر الصهيوني، وللباحثين في الروايات الإسرائيلية في كتب التفسير والرواية وكذلك علماء التاريخ القديم والوسيط وعلماء الآثار، فالبحث في التلمود شأنه كشأن أي تخصص آخر، يحتاج إلى مقدمات معرفية تمكن الباحث من الولوج إلى مكمن المعرفة وإشكالاتها الظرفية بقدم راسخة ووعي مستنير، ومن هذا الباب سوف أتحدث عن ترجمة التلمود وأبعادها، لعل بعض الإخوة الأفاضل الذين شككوا بأهمية المشروع يدركون مدى أهمية الموضوع وأبعاده الحقيقية. أدركُ تماما أنه من غير اليسير الاعتراف بأن معرفة مجتمعاتنا العربية بالتلمود، هي معرفة عامة، وأن معظم ما بين أيدينا من الدراسات عنه قد جاءت انعكاسا انفعاليا للمشاعر المستعرة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وما يتسرب من معلومات مجتزأة عنه من هنا وهناك. فرغم الاحتلال الصهيوني للأرض العربية، وما يقتضيه ذلك من استنفار معرفي يستوعب مفاصل المشروع الصهيوني وتسويغاته الدينية والتاريخية، فإن الدراسات العلمية التي تتناول التراث الديني اليهودي بلسان عربي ما تزال نادرة جدا. ولا يختلف أحد من المثقفين العرب أن ترجمة المصادر اليهودية الأصيلة كالتلمود البابلي الى اللغة العربية هي من أولى وأهم الأمور التي ينبغي الانشغال بها، إلا أن تردي حركة الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية على وجه العموم يلقي بظلاله على عموم الحركة العلمية في العالم العربي؛ فعدد الكتب التي تُرجمت إلى العربية منذ ثلاثة عقود (1970-2000) بلغ 6881 كتابا، وهذا الرقم يعادل ما نقل إلى اللغة الليتوانية التي يبلغ عدد الناطقين بها قرابة أربعة ملايين إنسان فقط، وإذا ما نظرنا إلى عدد الكتب التي ترجمت إلى اللغة العربية منذ عصر المأمون (ت 813م) إلى عصرنا الحالي فإن عددها يقارب مائة ألف كتاب، وهذا الرقم يساوي ما تترجمه إسبانيا في سنة واحدة!. وإذا نظرنا إلى الجهود الجبارة والقديمة التي بذلها الغربيون لترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية، فإننا سندرك أهمية فهم ودراسة الأديان والثقافات الأخرى لتحقيق النهضة والتقدم الحضاري، فقد بدأت ترجمة القرآن الكريم إلى اللاتينية على يد الراهب الإنجليزي "روبرت الرتيني" والراهب الألماني "هرمان". وكان ذلك عام 1143م، وظلت هذه الترجمة مخطوطة في نسخ عدة، يتداولونها في الأديرة مدة أربعة قرون إلى أن قام "ثيودور بيبلياندر" بطبعها في مدينة "بال" في سويسرا عام 1543م، وكانت هذه الترجمة منطلقا للعديد من الترجمات بمختلف اللغات الأوروبية، فظهرت الترجمة الإيطالية عام 1547م ثم الألمانية عام 1616م والفرنسية عام 1647م. ولم تبدأ مشاركة المسلمين في ترجمة القرآن إلى اللغات الأوروبية إلا في بداية القرن العشرين، مثل "حميد الله" الذي ترجم القرآن إلى الفرنسية، و"صدر الدين" إلى الألمانية، و"أحمد علي أمير" إلى الإنكليزية. ولا يختلف الدارسون للحضارات الإنسانية على مر التاريخ بأن الحضارة الإنسانية هي جملة من الإنجازات التراكمية التي تأثرت وأثرت ببعضها؛ فكما ترجم علماء العرب أيام المأمون كتب الحضارتين اليونانية والفارسية إلى العربية، وكانت تلك الترجمات ذات أثر واضح في الحضارة العربية الإسلامية، وكتابات ابن رشد وابن سينا والفارابي كانت موضع إعجاب وتقدير من قبل العديد من المثقفين في أوروبا في القرون الوسطى، وهكذا لم تفلح المواقف المناوئة التي حظرت وحرّمت قراءة كتب الآخرين أو ترجمتها من التواصل المعرفي بين المثقفين المسلمين والغربيين؛ فقد أسهمت حركة الترجمة منذ أيام المأمون في ظهور دراسات نقدية ومقارنة في الحقول العلمية والدينية والفلسفية، وكان لهذه الحركة الدور الأكبر في الإنجازات الحضارية الإسلامية والغربية، فاختلاف ألوان المعارف واتجاهاتها حفّز الإنسان باستمرار على المعرفة والتعارف وفق حقائق مقرة لبناء الجسور بين المجتمعات الإنسانية بمنظور حقيقي وليس تحليلي. وتمثِّل ترجمة التلمود البابلي هذه خطوة نوعية في سبيل الكشف عن أهم مصدر من مصادر الروايات الدينية الإسرائيلية التي اخترقت مساحة غير يسيرة من تراثنا الإسلامي وخاصة كتب التفسير وقصص الأنبياء، كما تقدم هذه الترجمة خدمة عظيمة لدارسي السنة النبوية المهتمين بتنقيتها من شوائب الإسرائيليات. وتسهم ترجمة التلمود في التعرف على ملامح الشخصية اليهودية التي امتزجت فيها ملامح الاستعلاء العنصري بتعاليم الشريعة "الموسوية" حسب زعمهم، كما ستسهم ترجمة التلمود في تأسيس علم يهوديات عربي، وفي الوقت الذي أصبحت فيه دراسة الأديان علما مستقلا وتخصصا دقيقا في كثير من الجامعات الغربية فإن دراسة الأديان في جامعاتنا العربية ما تزال ضعيفة ومختزلة في أغلب الأحيان على ما كتبه السابقون. إن ترجمة التلمود تمثل واجبا علميا وفريضة إسلامية ومتطلبا وطنيا واقعيا؛ فالتلمود يشكل قاعدة معرفية لفهم العقل اليهودي واستيعاب ملامح الشخصية اليهودية والتعامل مع المشروع الصهيوني الذي نجح في "اختطاف ديانة اليهود" وسعى إلى تسويغ جرائمه من خلال تراثها الديني. لست أبالغ عندما أقول إننا، نحن العرب والمسلمين، أولى الناس بالاهتمام بدراسة التراث الديني اليهودي الذي يمثل التلمود البابلي أكبر مستودع له؛ فالتراث اليهودي قد تشرب في كثير من ملامحه ثقافة الشعوب القديمة في منطقتنا: المصريين القدماء والكنعانيين والبابليين واليبوسيين والفرس وغيرهم، ففي دراسة التلمود نستطيع إدراك مدى تفاعل تلك الشعوب فيما بينها في صياغة الآراء والتصورات الدينية والثقافية. إن تحريم ترجمة الكتب الدينية لغير المسلمين أو تحريم قراءتها من قبل علماء الأمة وخبرائها لا يعبر عن الموقف الحضاري الصحيح، وهو لا يخدم واقع الحال سوى أعداء الأمة الذين يراهنون على جهلها وانغلاقها، فكيف يمكن للأمة أن تتعامل مع التحديات التي تشكلها الدولة اليهودية الكبيرة التي تفرضها العولمة الثقافية وتقنيات الاتصال والتواصل الحديثة وثورتها. ولا يقتصر التلمود على العقائد الدينية والجوانب الروحية والأحكام العملية والمواعظ والروايات الأسطورية، وإنما يتجاوز ذلك إلى الجوانب الفكرية والثقافية والسلوكية، فهو كل ذلك المزيج الذي يعكس ملامح الشخصية اليهودية، منذ عصر سيدنا موسى عليه السلام في القرن الثالث عشر قبل الميلاد إلى نهاية عصر الشُّرّاح في بابل نهاية القرن الخامس الميلادي، وما تبعه من شروحات حتى مطلع القرن العشرين الميلادي. وتظهر أهمية دراسة التلمود من كونه يعد التفسير المعتمد والشرعي للنصوص التوراتية عند اليهود الأرثوذكس، وهذا يعني أن أي تفسير للتوراة يخالف ما جاء في التلمود لا يمكن أن يكون مُعتمدا لديهم، وفق هذه النظرة، فالتلمود يفرض سلطته على النص التوراتي ويجعله تابعاً له عملياً، فالتلمود يحكم على التوراة ولا تحكم التوراة على التلمود، وإذا حدث وأن قدم التلمود تفسيراً مخالفاً لنصوص التوراة فإنه يعمل به ويقدم على كل معنى آخر لذلك النص. لا يقتصر أثر التلمود في الواقع اليهودي على الاتجاهات الدينية الحزبية أو غير الحزبية، وإنما يتعدى ذلك ليشمل البنية الفكرية والأيديولوجية للعديد من الاتجاهات والقوى السياسية في إسرائيل وخارجها، بل إن أثر التلمود قد تركَّز في اللاوعي اليهودي حتى عند العديد من العلمانيين واليساريين اليهود، وأصبح بمثابة قانون شفوي وسلوك عفوي في المجتمع الإسرائيلي. التلمود هو المكون الأساس لليهودية التاريخية التي امتزجت فيها التعاليم الدينية النظرية بالحياة العملية، فهو يتجاوز المعتقدات الدينية الغيبية والطقوس الدينية لليهود ليشتمل إلى جانب ذلك على الهوية القومية والمنطلقات السياسية والمرتكزات الثقافية التي تشكل العقل والفكر والشخصية اليهودية. وهذا التلمود- بشقيه المشنا والجمارا- هو عمل موسوعي ضخم قام به العديد من العلماء والشراح والرواة اليهود خلال فترة تقارب 700 سنة (200ق.م–500م)، وعلى هذا الأساس فقد تأثر بمؤثرات ثقافية ودينية مختلفة، كالثقافة اليونانية والرومانية، كما أن البحث في الأصول التشريعية والأسطورية للروايات التي جاءت في التلمود يشير إلى مؤثرات بابلية وفارسية ومصرية. وقد أطلق على الشروحات التي تمت في العراق اسم "التلمود البابلي" وهو شرح واسع لنصوص المشنا، يتجاوز التلمود الأورشليمي الذي اقتصر على شرح بعض أبواب المشنا وجاء غامضاً ومختصراً، ولعل الظروف السياسية والاجتماعية التي حظي بها اليهود في العراق قد ساعدت في إنجاز هذا العمل الذي امتد زمنا يقارب ثلاثمائة عام من 219م-500م. وأما التلمود الفلسطيني فهو تلك الشروحات التي قام بها علماء اليهود في فلسطين في طبرية وقيسارية وصفورية في فلسطين من عام 219م-359م، ويطلق عليها اسم التلمود الفلسطيني. يقسم التلمود من حيث موضوعاته إلى قسمين رئيسين: "الهالاخا" و"الهاجادا"، وتشمل الهاجادا على الموضوعات المرتبطة بالفكر والمخيلة من الأمثال والعادات والخرافات والحكايات والقصص والمواعظ، وتشتمل هذه الموضوعات قرابة ثلث التلمود، في حين تشتمل الهالاخا على الأحكام والطقوس الدينية إلى جانب الحقوق والواجبات التي ينبغي على اليهودي القيام بها. كانت "الهالاخا" هي النظام الذي من خلاله عاش اليهودي يهوديا في الماضي، وينبغي أن يعيش عليه في المستقبل، وهي تفسر السبب الأساس الذي مكَّن اليهود كأقلية من الحفاظ على خصوصيتهم دون الاندماج في الأغلبية المحيطة بها على مر التاريخ. وما أن اكتمل تلمود بابل حتى أصبح هو النص الرسمي للتعليم وانتشر في سائر المجتمعات اليهودية في مختلف تجمعات اليهود، وأصبح النص ملزماً ونهائيا، ولم يختلف جمهور العلماء التلموديين اليهود على وصف غير اليهود، ومنهم المسيحيون، بالوثنيين، ونظراً لما أحس به المسيحيون من إهانة لهم ولعقائدهم من قبل اليهود فقد أصدر الإمبراطور جوستنيان أوامره عام (553م) بمنع نشر التلمود وتوزيعه في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية، كما أدان هذه الكتاباتِ التلموديةِ كبارُ أحبار الكنيسة، أمثال يوليوس الثالث، وبول الرابع، وبيوس الرابع، وغريغوري الثالث عشر، وكليمنت الثامن، وإلكسندر السابع، وبيندكت الرابع عشر، والبابا غريغوري التاسع، والبابا أينوسنت الرابع، وذلك لاحتوائها على التحقير والتجديف ضد المسيحية، وأصدر العديد منهم أوامره بإحراقها لأنها تؤدي إلى انتشار الهرطقات. وخشيةً من غضب المسيحيين في أوروربا فقد استأصل اليهود جميع المقاطع التي تنتقص من المسيحيين وعقائدهم في طبعة التلمود التي ظهرت عام 1578م في "بازل" في سويسرا. لقد كان للتراث التلمودي الأثر الأكبر في صياغة الهوية اليهودية القائمة على العرقية الانفصالية المقدسة، والتي وإن مكنت اليهود من الاستمرار والبقاء رغم صعوبة وتعقيدات المراحل التاريخية التي مرت بها المجتمعات اليهودية، إلا أنها قد أسهمت أيضا في تعميق المواقف المتطرفة الداعية لكراهية غير اليهود وانتهاك حقوقهم، واستلاب أراضيهم وممتلكاتهم، وغيرها من الممارسات التي تتبناها الحركة الصهيونية اليوم، وتسوِّغ من خلالها جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. إن ترجمة التلمود البابلي تمثل منطلقا للدراسات المختصة في الجامعات العربية والإسلامية حول موضوعات متعددة وإشكاليات جاءت في التلمود، كما تعطي هذه الترجمة الفكر العربي فرصة لفهم الروح اليهودية، وبناء تصور أوضح للعلاقة المعقدة بين الهويتين الدينية والقومية للمشروع الصهيوني ولليهودية على وجه العموم.