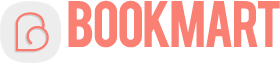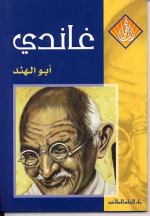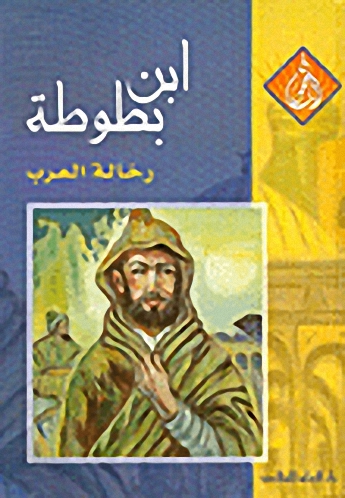شعر النابغة الجعدي
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
الكتاب من تحقيق عبد العزيز رباح، الكتاب طبعة أولى وهو قصائد ودواوين للنابغة وصَلَنا من شعر النَّابغة الجَعْدي عدد لا بأس به من القصائد والمقطوعات، عدا النتف والأبيات المفردة، وقد جاء عدد من قصائده بروايات مختلفة تتفاوت في الطول، وقد تتفاوت في بعض الألفاظ أيضًا، وقد جمع شعره وحقَّقه مرتبًا إياه على حروف الألفبا: عبدالعزيز رباح، وألحق به ما نسب إليه وإلى غيره من شعر، وقد استفاد، كما يقول، من عمل ماريا نلينو (بنت المستشرق الإيطالي المعروف كارلو نلينو)، التي كانت قد جمعت شعر الشاعر ونشرته محققًا ومشروحًا بالإيطالية سنة 1953م[1]، ورغم الجهد الذي بذله المحققان فقد بقيت ثغرات في بعض القصائد ينتقل فيها الكلام من معنى إلى آخر لا اتصال له به، كما ظلت هناك بعض الأبيات التي لم يستطيعا أن يعيِّنا مكانها في القصيدة التي رأيَا أنها منها، فكانا يثبتانها في نهايتها. ورغم هذا كله فإن الإنسان يستطيع أن يخرج بصورة لا بأس بها لفن النَّابغة الشعري، ويتذوق شعره ويستمتع به. وفي شعر النَّابغة هجاءٌ ومفاخرة، وهما أغلبُ الشعر عنده، كما أن عنده غزلًا، لكنه لا يأتي أبدًا مستقلًّا ولا طويلًا، بل هي أبيات مرافقة للغرض الأصلي في القصيدة التي وردت فيها، ومثل الغزل في ذلك وصفُه للخمر، وكذلك نظراته الحِكْمية، وثمة أيضًا أبيات في مدح الرسول عليه السلام والاعتزاز بالإسلام، كما أن هناك أبياتًا أخرى تأتي في تضاعيف بعض قصائده تصور حزنه الأليم على أخيه وَحْوَح وتمجد خلاله ومروءته وشهامته، ومثل ذلك الأبيات التي يصوب فيها ناظريه إلى الماضي متذكرًا شبابه ومسترجعًا أوقات الهناء التي عاشها هناك، ومتحسرًا على مضي ذلك كله إلى عالم الفَناء، وكذلك تلك الأبيات التي يتحدث فيها عن الراحلين من قومه، وفي عدد من قصائده تقابلنا أبيات غير قليلة في وصف الفرس، وهو ما اشتهر به النَّابغة عند القدماء[2]، وهذا كله غير القصيدة التي يبدؤها بتحميد الله وتوحيده مؤكدًا أن من لم يقل ذلك فقد ظلم نفسه. والحق أن وصف النَّابغة للخيل هو أقل شعره عندي جاذبية، صحيح أنه ومثله من شعر الشعراء الآخرين كان يعجب القدماء، لكنهم إنما كانوا ينجذبون إليه لِما فيه من الغريب، أما الناحية الفنية وما تحدثه من نشوة في النفس والعقل فإني لا أجدها في ذلك اللون من الشعر الذي يبدو فيه الشاعر عادة وكأنه قد تخلت عنه تلك الأحلام الدافئة التي تجعل من الشعر شعرًا، فإنه يذهب في تقصي أجزاء ناقته ووصفها وصفًا عقليًّا لا أثر فيه للشعور، وتشبيهاته حينذاك تأتي ميتة؛ إذ إن وجه الشبه فيها غالبًا سطحي لا تحليق للخيال فيه، فكأنه مجرد وسيلة تعليمية يراد بها التفهيم والتقريب. وفضلًا عن ذلك، فينبغي ألا ننسى أن الناقة والحصان اللذين شُغف الجاهليون والإسلاميون بوصفهما والإطالة في ذلك إطالة مسرفة في غير قليل من الأحيان لم يعد لهما الآن نفس الدور الذي كانا يقومان به في حياة العربي القديم، ولا ترتبط حياتنا بهما كما كانت حياة ذلك العربي القديم ترتبط بهما، بل إن الأغلبية الساحقة منا لا تستطيع أن تعرف أسماء أجزاء جسميهما أو الأدوات التي توضع عليهما مما هو محل الوصف والتطويل في شعرنا القديم، فلقد أصبحنا نستعمل اليوم السيارة والقطار والطائرة لا الجمل ولا الحصان، بل إن أي شاعر لو وقف اليوم وقفة نظيره القديم فوصف لنا أجزاء أية وسيلة من وسائل مواصلاتنا هذه بالطريقة التي كان القدماء يصفون بها الحصان أو الناقة فلا شك أنه سيكون مملًّا غاية الإملال، ولا أظنه سيهتم بكلامه أحد إلا المهندسون والميكانيكيون وأشباه ذلك؛ إذ الموضوع بهذه الطريقة يخلو تمامًا من الشاعرية، أو يكاد[3]. ثم إن هذا الغرض الشعري بالذات هو من الأغراض التي يكثر فيها الغريب الحُوشي من الألفاظ، إن لم يكن يأتي على رأسها، مما يضاعف برَمَنا به.