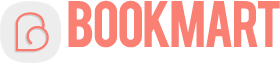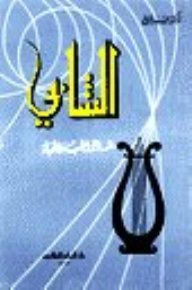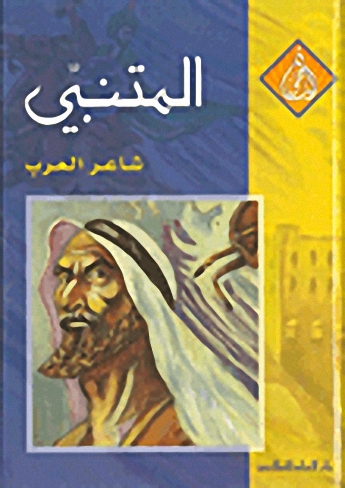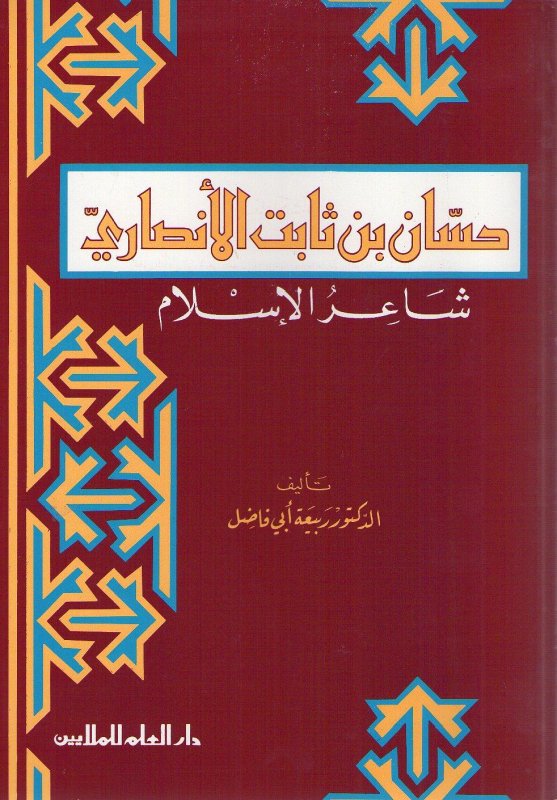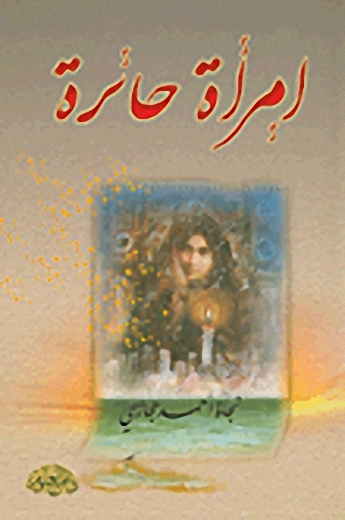حداء
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
فالشعر كالحديقة التي تتسع لجميع الأزهار بمختلف أنواعها وألوانها وعبق رائحتها وبذلك فالشعر يتسع لكل الأنماط والألوان الشعرية سواء كان النص عموديا أو نثريا، وبذلك ارتأيت أن أتصفح مجموعة “حُداء ” وأحكم عليها لا من خلال جبة القافية التي ألبسها لها الشاذلي القرواشي في أغلب قصائد المجموعة ولكن بغية الغوص في الشعر بما هو شعر دون تصنيفه أو تبويبه والنظر إليه على أنه رؤية إبداعية وعمق شعري. الشاعر الشاذلي القرواشي أيقظ فينا روح الشعر بصحراء نائمة تفرش له الآهات لنسمع وقع خطى الإبل على رمالها وحداء سائقها، فهو حادي العيس يقتنص مواويلهم وغناء الرعاة ليكون الحداء أبياتا تسعدنا بالتحليق نحو الحياة يقول الشاعر (ص84): ” غنيت كي أرث الفصاحة والمدى ورعونة الشجر العنيد. غنيت كي أصف الكواكب والفصول وما أرى، علي أحرك ذرة النيران في ماء القصيد، غنيت كي أزن المسافة بالصدى في روح أغنيتي وأمضي نحو أقمار السلالة أقتفي طيفي الشريد” ومع هذا فحداء الشاعر الشاذلي القرواشي ليس غناء بقدر ما هو لحن جمع بين عذوبة المعنى وسحر القافية المستمد من بيئة بدوية خالصة، موسيقى آتية من عمق الصحراء، لتورق غابة من نشيد ومقام “النهوند” فصار يغني بلحن شريد: “أنا لا أغني، ولكن تطير إلى الجهات. وتأتي على شكل لحن، تشف به المفردات. ولا ذنب لي غير أني أشير إلى نجمة من بعيد. ولم أخدش الورد يوما ولست النبي… ولكن دعاني القصيد فصرت دما في الصدى ولم أقترف غير حب النشيد”(ص97). كما لا يقتصرعند الشاعر الشاذلي القرواشي الحداء أو “التهيليم “، كما يسميه رعاة الإبل بالجنوب التونسي، هنا على “حداء الأوب” الذي يقال خلال فترة العودة إلى المنازل حيث الأهل والمياه -على الرغم من تكرر لفظ الماء 23 مرة في كامل المجموعة دون اعتبار المفردات الدالة عن معنى الماء-ولا على”حداء الورد” الذي يكون لحظة التجمع حول البئر وبدء عملية السقي بل يتعداه إلى معاني الاشتياق للأرض التي تمثل الأهل و الوطن، هذا اللفظ الأخير الذي تكرر بدوره 23 مرة في كامل نصوص المجموعة و هذا التكرار ليس تكرارا عاديا حسب رأي فالتماهي بين اللفظين في العدد يشير إلى أن مصدر تكامل (الأرض – الماء) تكامل طبيعي فرضة الشاعر، كما تفرضه الضرورة الكونية وتفرضه البيئة العطشى للارتواء، فبارتواء الأرض التي تمثل الوطن مصدر الإلهام والترحل والثبات، الوطن الذي يحن إليه يرسم ملامحه، ليرتوي الشاعر بعبق اللغة التي تلهمنا بها الصحراء و قديما كان العرب يرسلون أبناءهم للبادية لتعلم فنون القول و فصاحة اللسان. فالشاعر الذي ينادي القوم مرتحلا، لا يحتاج إلا لإبل يركبهاللترحال،يذهب بنا الى جهات متعددة ودلالات أكثر إيغالا فهو الرحلة والراحلة والترحال والمرحول والرحل: “فسرت خلف حداء الركب مرتحلا قد جمع الرحل ما في الجسم من مزقي”(ص13) فهي رحلة الشاعر الباحث عن الذات وعن قيم الحياة ومعاني الإنسانية ووجودها فهي السفر من مكان إلى مكان عبر أزمنة مختلفة تعبر عن رحلة في نفس الشاعر، رحلة القصيد التي يجرها تارة ليطرق باب المحال لقفو طيف القصائد وينطق بالقصيدة التي تهمس له بأنها آتية يقول (ص51): “تأتي القصيدة والأنوار تملؤها كأنها الهودج السحري ينكشف يرف حولي شعاع النور مؤتلقا لعلني من دنان الغيب أرتشف لكنني حين أعلو الحرف تطعنني ذكرى الورود فيطغى الحزن والأسف” هذا ما أوحت له القصيدة عند انعطاف الروح وخلف المدارات البعيدة ليدخل القصيدة من هائهاليرتب الانوار في فلك الشعر والرؤى: “دخلت القصيدة من هائها دخلت القصيدة من روحي الحائرة دخلت ولم أرتج الباب خلفي… ولم أغلق الدائرة”(ص79) أي دائرة يقصد الشاعر؟ دائرة الشعر، أم دائرة المعنى، ففي الحقيقة هيّ رحلة بحث تميّزت كما قرأتها وتفاعلت معها بالقلق، قلق البحث عن المعنى والرّؤيا الشّعريّة التي تسكن à صاحبها، الذي بدا مطّلع على مختلف التّجارب قديمها وحديثها، مع حرصه الجلي على إخراج نصه إخراجا تصويريا يقوم على شد القارئ: ” أقفو مياه الضاد واللغة الحرون وما يؤوب من الشتات، … تعبت يا جدي الفرزدق من تعثر خطوة النيران في درج القصيد ومن خروجي المستمر إلى صحاري المفردات…”(ص80). كما يحتاج الشاعر، الليل للسهر والتفكير، والليل للكتابة، لأن الليل فكرة مشتهاة ترتحل وتعوي كفكرة بالفلاة، فالشاعر الذي أدمن ثوب الليل ليعلق في غسق القصيدة اسمها، ويتناثر ضوء القصائد كبرق في سماء الشعر ومع هذا فالشاعر محزون تحت سمائها يمضي ويزرع الروح روض لأن الشعر أواه القلوب، يفتح في الشاعر البصيرة لذلك نراه حريص على اختيار المعاني وترتيب المفردات فماذا سيكتب؟: ” جن البياض أبيت الليل أسألني ماذا سأكتب فيك الآن يا ورقي”(ص12) ولكن الشاعرالمحتفى بالشعر كأسلوب للتبليغ عن خلجات نفسه، وبالوطن وانقشاع ظلامالليل وبزوغ فجرالثورة لم يعلم مجيء الموت في عجل: “وما ظننت بأن الأرض ثائرة وما علمت مجيء الموت في عجل”(ص21). ذلك الموت هادم اللذات، والذي يشبههبغراب الموت الذي يرصد الأحلام ويبعد الأحباب وهو بذلك لا ينسى هموم أمته وشعبه الذي شبهه براكب السفينة التي تعصف بها الأمواج: “ونحن تحت رحى الطاعون تطحننا مثل الهشيم وشهد الروح ينخطف هذي الشام وذي النيران تلفحها كيف العراق على أكتافها تقف؟ ماذا دهاهم بنو المختار يا عمر الأرض ثكلى بلون النارتلتحف”(ص56). وهو ما جعل أغلب المقاطع الشعرية طغت عليها لفظة الموت أو الكلمات التي تحيل على الموت الذيأفرز لنا جملة من العواطف الكامنة في نصوصه بدت صريحة تارة وخفية تارة أخرى تقودنا إليها موسيقى الشجن والفرح: “شيعنني وغراب الموت يرصدني ماذا سيجدي زفير الشوق واللهف”(ص51). وكذلك في قوله: “صرت القتيل وليس الوهم أحجيتي وتلك أرضي مذاق الموت ترتشف”(ص55). و مع كل هذا الحزن و القلق، لا ينسى الشاعر أن ينقل لنا معزوفات الريح لليل، وهو يردد صدى مواويل البدو ودندنة تحرك صمت المكان فالشاعر الشاذلي تخلص من الحداء كمجرد همس وإشارة أو صوت لمناداة الإبل إلى غناء شعري، أدخل فيه من الكلمات الشعرية المغناة،( نص ص27: وهبت الطير أغنيتي…). ” لم الأيام ساكتة وقد ضيعت أبعادي وهذي الشمس قد هرمت على جلدي وأصفادي ونوق العمر متعبة فمن يستوقف الحادي” ليجمع عذوبة اللفظ وسحر القافية والبيان وغنى المحتوى والمعنى الذي استمده من المدونة الشعرية العربية ومن القص القرآني الذي استوحى منه أسلوبه حين تحدث عن قصة قابيل وهابيل ابني آدم: (ص9): ” الآن أنشب في الفراغ مخالبي علي أرى الإنسان في الإنسان هذي دما هابيل كيف أكفها مازلت أجهل حكمة الغربان” كما يتجلى التناص القرآني و حسن توظيفه في القصيدة التقليدية و مثيلتها من نظيراتها الحداثية على حد السواء عند الشاذلي، حين وظف سفينة نوح بطريقة فيها من الحبكة والتفنن في تصوير النص (ص22): تمضي السفينة لا أرض تعانقها كأنها في المدى كالشارب الثمل ومن معي فوق لوح الفلك قد ثبتوا وما همو جنحوا لليأس والكلل” كما أن توظيف التناص الذي يعتبر من أبرز التقنيات الفنية التي عني بها الشاعر واحتفى بها بوصفها ضربا من تقاطع النصوص التي تمنح النص ثراء وغنى كما في قوله مضمنا قصة ملكة سبأ ص27: ” بلقيس عادت بلا عرش ولا حرس هذا زمان وقيد الوهم طوقه لا تعبري الصرح راح وما ألفيت سارقه” لتحصل المشاركة والتداخل مع نص سابق عليه ليكون علاقة خاصة بين نص سابق ونص لاحق، عندما يهز في شبهة التفاح جذع نخلة الليل ليبزغ نور الكون (ص61): “هزي إليك بجذع نخلة ليلنا كي تبزغ الأنوار في الأكوان” من هنا جاءت هذه القراءة التي مردها الوقوف على الجوانب الإبداعية والفنية لدى الشاعر الشاذلي القرواشي مفعمة بلحظات الأمل والحزن، ألم الموت والحياة، وأمل الحب والحيرة، و التي عبر عنها بحيرة السؤال، وهمس القوافي وعناقها، لنسمع أوتار الكمنجة تقفز ليمطر القلب فوق لحن الصاعدين ليرمي لنا الشاعر شفاه الناي و نواحه كما في قوله: ” لا شيء غير الغيب يفقه سره ويقيم باللحن الطهور صلاته لكن فأسا أوجع الغصن الذي قد وثق الألحان، ثم أماته فتلعثم العصفور عند غنائه و مضي يرمم بالأنين سكاته ارتج غصن البوح في أحشائه وهو يرتل في الغياب مماته صدق الرواة على رخامة قبره مذ قيل إن اللحن صار رفاته”(ص45). وبما أن الشعر نتاج للمشاعر والأحاسيس فقد أفرز لنا شعره جملة من العواطف الكامنة مشبعة بالغنائية والتي من شأنها أن تجعل قارئ المجموعة يشعر بالصدق الذي يرمي الشاعر بثه في القارئبحدائه عن طريق العزف على أوتار الروح والوجدان.ليلامس أوتار الحب والحياة رغم مسحة الموت والحزن التي طغت على ألحانه. وفي الختام يمكن القول أن الشعر عند الشاذلي القرواشي نابع من شعوره بأهمية الكلمة والشعر وأهمية الشعور بهموم أمته قبل همومه التي طرحها في ثنايا الكتاب وهو بذلك يطرح فكرة التماهي بين الانسان والشعر يقول في احدى حواراته:”فإذا كان الشعر نابعا من شعور الانسان فهو يبقى ما بقي هذا الشعور وما بقي هذا الانسان واذا انتفى الشعر فعلينا ان ننعى أنفسنا وننعى البشرية جمعاء”.