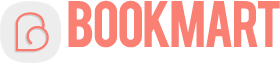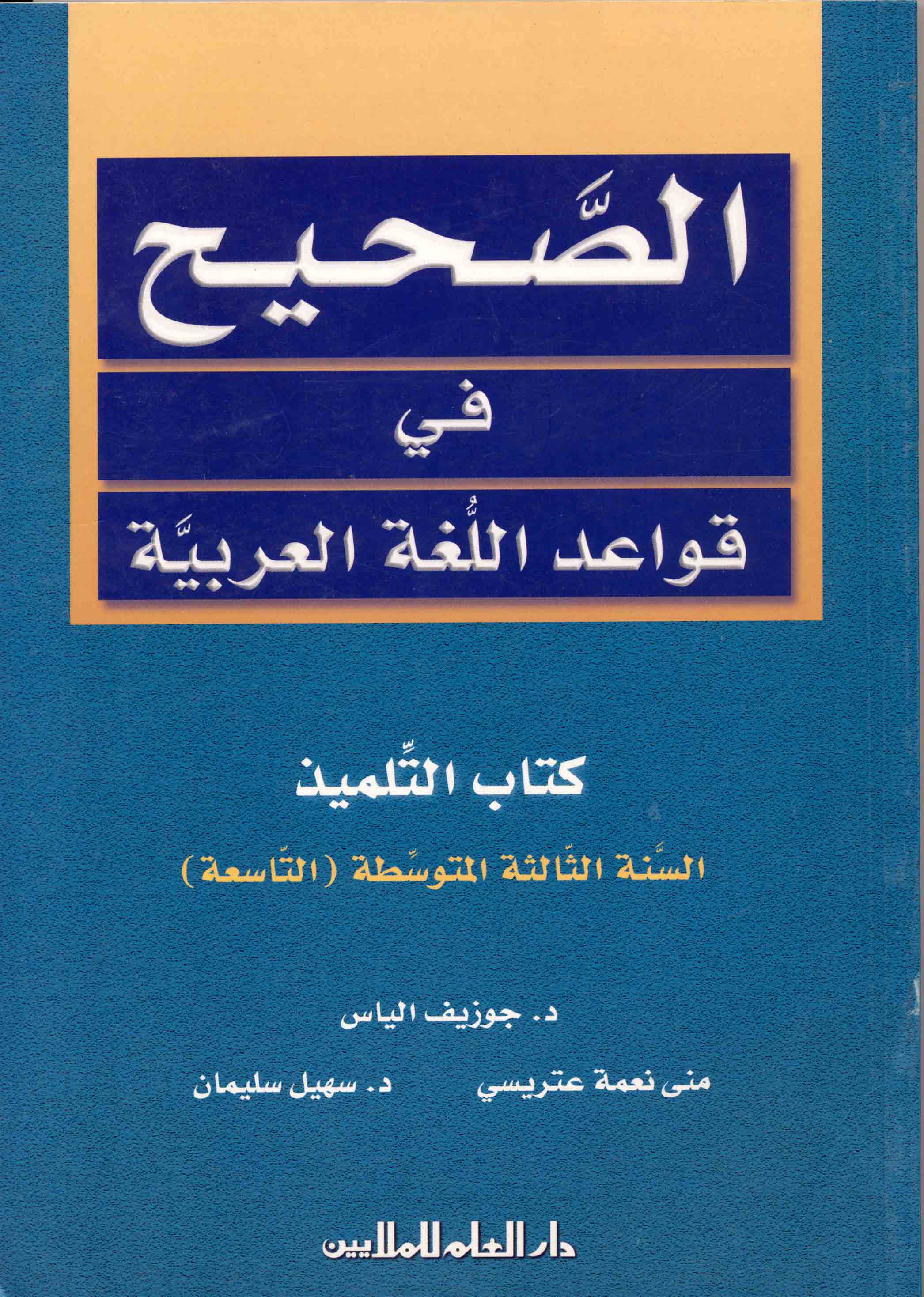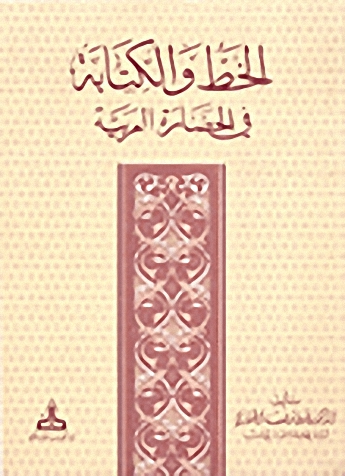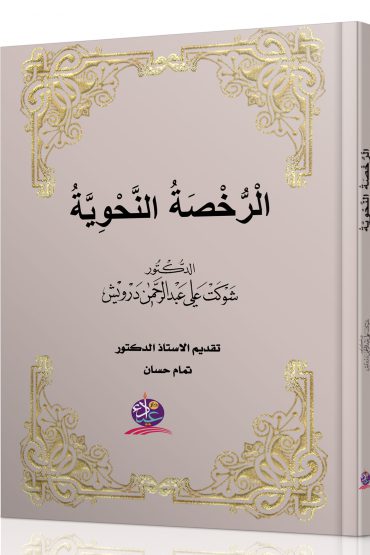
الرخصة النحوية
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
إذا كان النحو العربي وليد العناية بالنص القرآني، وكانت نشأة النحو في نظر النحاة حرصاً منهم على مجافاة اللحن؛ فإن هذه الغاية الشريفة لم تشفع لنص القرآن أن يكون مادة البحث، ولم تدع الأوائل من النحاة أن يختاروا الشواهد على صحة قواعدهم من القرآن أو من الحديث. لقد اعتمد النحاة في صياغة قواعدهم على المسموع من كلام قبائل وسط الجزيرة لما رأوه من أن هذه القبائل هي قبائل الفصاحة والنقاء اللغوي، وكان أخذهم عن هذه القبائل على رغم علمهم أن لهجاتها قد تختلف في قواعد تركيبها، بدليل نسبة بعض التراكيب إلى واحدة من هذه القبائل دون الأخريات. لقد كان عزوفهم عن استخراج الشواهد من لغة القرآن بسبب تعدد القراءات، أما تعدد لهجات القبائل المذكورة وهي: قيس وتميم وأسد وطيء وهذيل (وبعض كنانة كما يروي السيوطي) فلم تحل دون اعتماد النحاة على لهجات هذه القبائل في نطقها باللغة الفصحى. نقول: “عند استعمالهم اللغة الفصحى” لأن الموقف اللغوي للعرب في ذلك العصر كان يعتمد على ازدواجية لغوية ركناها اللهجة القبلية (التي يقول عنها النحاة: لغة قوم)، واللغة الفصحى التي تختلف صورتها من قبيلة إلى أخرى بحسب ما يصيبها من تأثير اللهجات القبلية. وإذا كان من المعروف أن منهج الدرس اللغوي الحديث يرفض دراسة أكثر من لهجة واحدة في وقت واحد؛ فإنني أعجب لما صدر عن النحاة من قبول تعدد اللهجات ورفض تعدد القراءات. كان من الطبيعي أن يؤدي اختلاف اللهجات التي تستعملها هذه القبائل واتحاد القاعدة المستخرجة من كلام هذه القبائل إلى أن تحكي القاعدة واحدة مما يلي: 1. اتفاق أصحاب اللهجات بالنسبة للتراكيب الشائعة في القبائل والتقعيد لهذا الاتقاق. 2. التقعيد للظاهرة التركيبية ذات الغلبة في الاستعمال لدى القبائل، والإشارة إلى غيرها من الصور المختلفة التراكيب والأقل شهرة بنسبتها إلى الشذوذ أو القلة والندرة أو التوسع، وجعلوا أكثر ذلك مرفوضاً لدى الاستعمال. لم يحتف النّحاة بقرينة نحويّة دالّة على المعنى قدرَ عِنايتهم بالإعراب. أما القرائن النحويَّة الأُخرى الدَّالة على المعنى فلم يمنحوها قدراً من الانتباهِ إلاّ عندما يتوقف إدراك المعنى على واحدة منها بعينها. فإذا لم يتضح الفاعل والمفعول في الجملة كما في: ضَرَبَ مُوسَى عِيسَى. دعا النُّحاة إلى حفظ الرتبة في الجملة فكان الأول فاعلاً والثاني مفعولاً. وإذا قرأوا قول الشاعر: نَحْنُ الأُلَى فَاجْمَعْ جُمُو عَكَ ثُمَّ وَجِّههُمْ إِلَيْنَا أدركوا أن قرينة التضام لم تتحقق في البيتِ لإهمال إيراد صلة الموصول (الألى)، ثم استخرجوا المعنى من قرينة أخرى هي: “فاجمع جموعك إلخ..” أي: نحن الألى نتحداك. وإذا قرأوا قوله تعالى: “وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ اْلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ” (فاطر45). فطنوا إلى عدم ذكر المرجع، وأن ذلك مخالف لمطلب الربط، ولكنهم عندما يجدون كلمة “دابّة” يعلمون أنّ المراد: ظهر الأرض. وهكذا. كانت مناسبات التفكير في معاني هذه النصوص قليلة إلى حد ما بالنسبة لشيوع دلالة الإعراب الذي فتن به النحاة وهو لا يبوح بعلاماته إلا في حدود معينة يغطي بعضها التقدير وبعضها الآخر المحل على النحو التالي