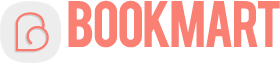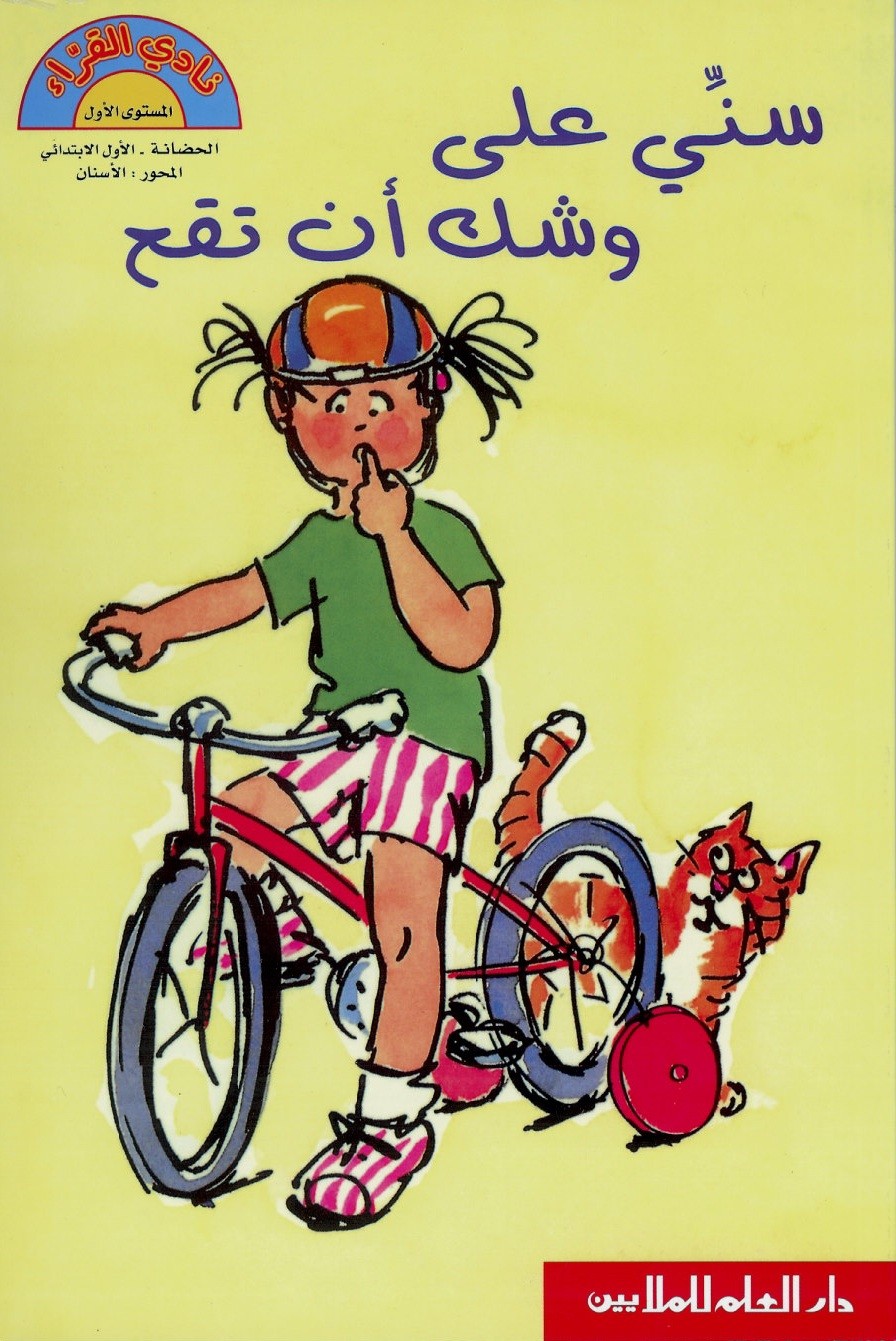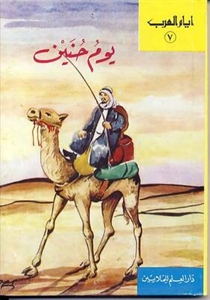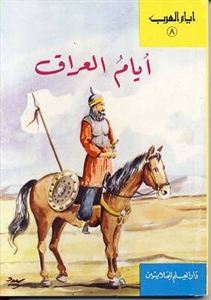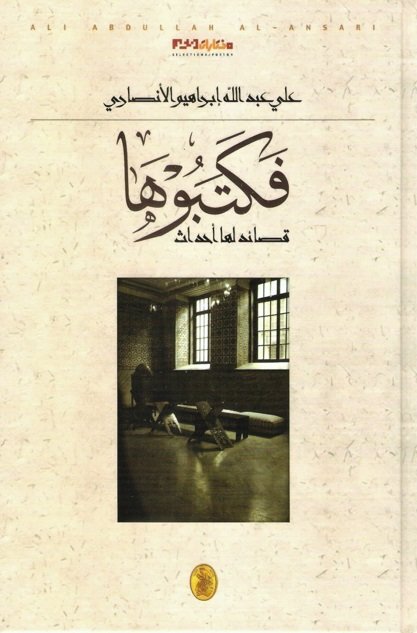
فكتبوها - قصائد لها احداث
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
هو عبارة عن مجموعة من القصائد المختارة التي سلط الباحث الضوء من خلالها على ما ارتبط بها من أحداث ليعرضها بأسلوب قصصي جذاب وثريٍّ يتضمن معلومات عن أشخاص الحدث. وجاء الكتاب، الذي يهدف الانصاري من خلاله إلى التقريب بين القارئ وأجواء القصيدة والكشف عن خلفياتها، في 558 صفحة من الحجم الكبير، تمّ تقسيمها إلى ثلاثين فصلا. تطرق في كل فصل منها إلى قصيدة محددة. ومن بين الشعراء الذين تناول الباحث إحدى قصائدهم نذكر عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي وعمرو بن مالك (الشنفرى) والحارث بن عباد البكري ودريد بن الصمة، تماضر بنت عمرو (الخنساء) ومتمم بن نويرة وجرول بن أوس والحسن بن زريق وغيرهم.. ويعتبر الكتاب نتاج مجموعة من البحوث حول قصائد كثيرة، حيث يقول الباحث في هذا السياق: (ولا تعجب حين أقول إنني بحثت في مناسبة 200 قصيدة تقريبا، لأنتخب منها، ولا أعتقد أن نصا ساعدني كنص الفرزدق «لولا التشهد كانت لاؤه نعم»، ولا نصا أتعبني في جمع معلوماته كنص الوزير بن زريق «أستودع الله في بغداد لي قمرا»، وكم انتهيت تماما من نص فرفضته بعد ذلك لصعوبة فيه ثم عدت اليه، كلامية العرب للشنفرى وقصيدة الخنساء رضي الله عنها في رثاء صخر أخيها). ومنذ مقدمة كتابه، اختار المؤلف أن يؤكد لقارئه أنّ القصائد إذا ارتبطت بأحداث حقيقية تكون أجزل من «تلك اليتيمة المناسبة». وفي هذا الاطار يقول: «تمر الأيام.. وتكتب الليالي.. ويمحو الوقت.. وتظل الآثار.. ويعفو الزمن.. ثم يأتي من يمسح غبار القِدم.. ويزيل ستر الضياع.. ليسجل ما يستطيع أن يُسجل من الحدث.. فيقرؤه الناس.. كلٌّ حسب ما يظن.. ويرى.. يعتقد.. فيصبح التاريخ- الكتاب الأكبر-:رؤى.. ومعارف.. يختلف حسب اختلاف الأخلاق.. والأعراف.. والمبادئ». ولئن أصر الباحث علي الانصاري على التأكيد بأنّ ما قدمه في مؤلفه ليس حدثا جديدا ولا سبقا غير مسبوق، إلاّ أنّنا نخال ذلك من باب التواضع، فنحن ندرك تماما أنّ البحث في هذا المجال يظل «أصعب السهل وأسهل الصعب» خاصة اذا اقترن الذاتي بالموضوعي فلكل باحث عينٌ ورؤيةٌ في تقديم ما بين يديه من أحداث وشخصيات. وهو ما يشكل التحدي الأول الذي يواجه الباحث أو المؤرخ. ليظّل السؤال قائما: إلى أي درجة يمكن أن يكون الباحث موضوعيا حقا؟ حيث لم يكتفِ الانصاري بتناول الاحداث وإنما تطرق إلى الشخصيات وصفاتها وأخلاقها. وهو ما احتاج منه إلى العودة إلى عدد هام من المصادر التاريخية ومراجعتها ومقارنة ما جاء فيها ليتم ربط القصيدة الواحدة بأكثر من حدث وربما يُعرض الحدث الواحد بأكثر من رواية ورؤية. وهوما يتطلب قدرا عاليا من التركيز لنقل «ما يتبين أنه أقرب للواقع». وليس بالجديد القول إنّ القصائد شكّلت مرجعا مهما لدراسة مرحلة تاريخية معينة وما مرّ به المجتمع من تغيرات. ولعلنا نستحضر، هنا، ما قاله أبو فراس الحمداني بأنّ (الشعر ديوان العرب وعنوان الأدب) وهو المخبر عن أحوالهم وأوضاعهم وتاريخهم. وكأننا بعلي الانصاري أراد من خلال هذا الكتاب ليس الاقتراب فحسب من واقع القصيدة ومناسبتها وإنما أيضا إثبات أن المبدع عموما في أي زمان ومكان هو بالأساس ابن بيئته، فهو يتشرب منها ما يحيط به ليعيد إنتاجه في شكل مادة إبداعية قد تكون لوحة أو قصيدة أو كتابا أو أي شي آخر.. وتظل القصيدة عملا مزدحما غنيا بالرسائل فهي وإن كانت تمثل مادة خصبة لفهم أعماق الذات الإنسانية فإنها أيضا قادرة على أن تشكل مصدرا هاما لفهم التاريخ الذي وإن بدا واضحا فإنه أكثر جدلا من أي شيء آخر. فنحن بحاجة لمعرفة من قال ماذا ولماذا وفي أية ظرف حتى نفهم. إذ لا ينفصل الحدث أو القول على حدٍّ سواء عن إطاره ومسبباته وظروفه. إنّ ما قدمه علي الانصاري في هذا الكتاب يستحق أن يكون مرجعا هاما للأكاديميين والباحثين والمهتمين بدراسة الشعر العربي وما ارتبط به من أحداث، لا تتعلق فحسب بشخصية الشاعر وما مرّ عليه من ظروف قد تبدو شخصية وإنما أيضا بالظروف العامة الاجتماعية والسياسية والتاريخية للاطار المكاني والاجتماعي الذي نُظِمت فيه القصيدة. وإن كنا نقدم هذا الكتاب على عجل بما تفرضه طبيعة هذا المقال، فإننا على ثقة بأنه سيكون مرجعا مهما يستحق أن يقف عنده الأكاديميون والنقاد لمزيد البحث والتمحيص. وتجدر الإشارة إلى أن علي عبد الله إبراهيم الانصاري شاعر وباحث قطري. كان قد صدر له «على ضفاف البوسفور» و«الشخصية الورائية وأثرها في تأسيس الدول». { كاتبة تونسيةكتبت - إشراف بن مراد عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في لبنان، صدر مؤخرا للباحث والشاعر القطري علي عبد الله إبراهيم الأنصاري، كتاب بعنوان «فكتبوها.. قصائد لها أحداث» وهو عبارة عن مجموعة من القصائد المختارة التي سلط الباحث الضوء من خلالها على ما ارتبط بها من أحداث ليعرضها بأسلوب قصصي جذاب وثريٍّ يتضمن معلومات عن أشخاص الحدث. وجاء الكتاب، الذي يهدف الانصاري من خلاله إلى التقريب بين القارئ وأجواء القصيدة والكشف عن خلفياتها، في 558 صفحة من الحجم الكبير، تمّ تقسيمها إلى ثلاثين فصلا. تطرق في كل فصل منها إلى قصيدة محددة. ومن بين الشعراء الذين تناول الباحث إحدى قصائدهم نذكر عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي وعمرو بن مالك (الشنفرى) والحارث بن عباد البكري ودريد بن الصمة، تماضر بنت عمرو (الخنساء) ومتمم بن نويرة وجرول بن أوس والحسن بن زريق وغيرهم.. ويعتبر الكتاب نتاج مجموعة من البحوث حول قصائد كثيرة، حيث يقول الباحث في هذا السياق: (ولا تعجب حين أقول إنني بحثت في مناسبة 200 قصيدة تقريبا، لأنتخب منها، ولا أعتقد أن نصا ساعدني كنص الفرزدق «لولا التشهد كانت لاؤه نعم»، ولا نصا أتعبني في جمع معلوماته كنص الوزير بن زريق «أستودع الله في بغداد لي قمرا»، وكم انتهيت تماما من نص فرفضته بعد ذلك لصعوبة فيه ثم عدت اليه، كلامية العرب للشنفرى وقصيدة الخنساء رضي الله عنها في رثاء صخر أخيها). ومنذ مقدمة كتابه، اختار المؤلف أن يؤكد لقارئه أنّ القصائد إذا ارتبطت بأحداث حقيقية تكون أجزل من «تلك اليتيمة المناسبة». وفي هذا الاطار يقول: «تمر الأيام.. وتكتب الليالي.. ويمحو الوقت.. وتظل الآثار.. ويعفو الزمن.. ثم يأتي من يمسح غبار القِدم.. ويزيل ستر الضياع.. ليسجل ما يستطيع أن يُسجل من الحدث.. فيقرؤه الناس.. كلٌّ حسب ما يظن.. ويرى.. يعتقد.. فيصبح التاريخ- الكتاب الأكبر-:رؤى.. ومعارف.. يختلف حسب اختلاف الأخلاق.. والأعراف.. والمبادئ». ولئن أصر الباحث علي الانصاري على التأكيد بأنّ ما قدمه في مؤلفه ليس حدثا جديدا ولا سبقا غير مسبوق، إلاّ أنّنا نخال ذلك من باب التواضع، فنحن ندرك تماما أنّ البحث في هذا المجال يظل «أصعب السهل وأسهل الصعب» خاصة اذا اقترن الذاتي بالموضوعي فلكل باحث عينٌ ورؤيةٌ في تقديم ما بين يديه من أحداث وشخصيات. وهو ما يشكل التحدي الأول الذي يواجه الباحث أو المؤرخ. ليظّل السؤال قائما: إلى أي درجة يمكن أن يكون الباحث موضوعيا حقا؟ حيث لم يكتفِ الانصاري بتناول الاحداث وإنما تطرق إلى الشخصيات وصفاتها وأخلاقها. وهو ما احتاج منه إلى العودة إلى عدد هام من المصادر التاريخية ومراجعتها ومقارنة ما جاء فيها ليتم ربط القصيدة الواحدة بأكثر من حدث وربما يُعرض الحدث الواحد بأكثر من رواية ورؤية. وهوما يتطلب قدرا عاليا من التركيز لنقل «ما يتبين أنه أقرب للواقع». وليس بالجديد القول إنّ القصائد شكّلت مرجعا مهما لدراسة مرحلة تاريخية معينة وما مرّ به المجتمع من تغيرات. ولعلنا نستحضر، هنا، ما قاله أبو فراس الحمداني بأنّ (الشعر ديوان العرب وعنوان الأدب) وهو المخبر عن أحوالهم وأوضاعهم وتاريخهم. وكأننا بعلي الانصاري أراد من خلال هذا الكتاب ليس الاقتراب فحسب من واقع القصيدة ومناسبتها وإنما أيضا إثبات أن المبدع عموما في أي زمان ومكان هو بالأساس ابن بيئته، فهو يتشرب منها ما يحيط به ليعيد إنتاجه في شكل مادة إبداعية قد تكون لوحة أو قصيدة أو كتابا أو أي شي آخر.. وتظل القصيدة عملا مزدحما غنيا بالرسائل فهي وإن كانت تمثل مادة خصبة لفهم أعماق الذات الإنسانية فإنها أيضا قادرة على أن تشكل مصدرا هاما لفهم التاريخ الذي وإن بدا واضحا فإنه أكثر جدلا من أي شيء آخر. فنحن بحاجة لمعرفة من قال ماذا ولماذا وفي أية ظرف حتى نفهم. إذ لا ينفصل الحدث أو القول على حدٍّ سواء عن إطاره ومسبباته وظروفه. إنّ ما قدمه علي الانصاري في هذا الكتاب يستحق أن يكون مرجعا هاما للأكاديميين والباحثين والمهتمين بدراسة الشعر العربي وما ارتبط به من أحداث، لا تتعلق فحسب بشخصية الشاعر وما مرّ عليه من ظروف قد تبدو شخصية وإنما أيضا بالظروف العامة الاجتماعية والسياسية والتاريخية للاطار المكاني والاجتماعي الذي نُظِمت فيه القصيدة. وإن كنا نقدم هذا الكتاب على عجل بما تفرضه طبيعة هذا المقال، فإننا على ثقة بأنه سيكون مرجعا مهما يستحق أن يقف عنده الأكاديميون والنقاد لمزيد البحث والتمحيص. وتجدر الإشارة إلى أن علي عبد الله إبراهيم الانصاري شاعر وباحث قطري. كان قد صدر له «على ضفاف البوسفور» و«الشخصية الورائية وأثرها في تأسيس الدول».